نوستالجيا أولاد كازا - سينما العثمــانيــة

ارتبط جيلنا بالسينما بروابط وجدانية، وتوطدت أواصر عشقه بالأفلام السينمائية، في غياب التلفزيون داخل أغلب البيوت أواخر الستينات وبداية السبعينات، وحتى إذا توفر هذا الجهاز، فإن المساحة الزمنية المخصصة للبث كانت قصيرة، وكانت البرامج تعرف شُحّا على مستوى إدراج الأفلام.
في ظل هذا الوضع المعيش، نما عند أولاد كازا عشق الأفلام، وأضحى ولوج قاعات السينما حلما لديهم، إلا أن تحقيق هذا الحلم لم يكن سهلا، على اعتبار أن توفير ثمن الدخول إلى القاعة كل أسبوع يعتبر من سابع المستحيلات، فكان علينا أن ننتظر حلول العيد، حيث نزور الأقارب والأهل والجيران، بحثا عن فلوس العيدية، فيما يشبه التسول، أو انتظار النجاح والانتقال من مستوى إلى آخر للحصول على جائزة أسرية، تتمثل في مشاهدة شريط سينمائي في إحدى القاعات، وبين الأعياد والنجاح، نسجل بعض الفلتات النادرة (ملي كانضبرو على الصرف).
سينما العثمانية، هذا الفضاء استقطبني وأنا طفل صغير، بحكم قربه من منزلنا، فكنت أزوره صحبة أصدقائي عدة مرات في الأسبوع للتفرج فقط على ملصقات الأفلام (حاليا / الأسبوع المقبل / عما قريب) ولم يكن هذا كافيا ليطفئ لهيب ولوج القاعة المتختر في صدري، فأضطر إلى توفير درهمين، كهدف أرسمه، لكن تحقيقه يكلفني أسابيع. حينذاك لا أتردد في الذهاب إلى سينما العثمانية التي كانت تعرض شريطين بسعر لا يتعدى درهما وخمسة وثلاثين فرنكا (سبعة وعشرين ريال)، بالإضافة إلى عشرين فرنكا(سنتيم) للمضيفة، وخلال فترة الاستراحة التي تفصل بين الشريطين أشتري حلوى (ميل فاي) أو (ربع وبيضة). لكن الجميل، هو بعد عودتي أحكي لبعض أصدقائي أحداث الفيلم، فيما يشبه التباهي.
من طرائف سينما العثمانية التي مازالت عالقة بذهني، أن المتفرج يخجل التوجه إلى المرحاض، أثناء بث الفيلم، خشية التشهير به بصوت عال من قبل البعض، أما عندما ينقطع البث فجأة لأسباب تقنية، فإن مصير التقني هو الشتم (واالقرع ـ واالقرع). وأذكر أن حدثا وقع ذات مرة، ذلك أن شخصا يجلس في البالكون فتح علبة النّفْحَة ورمى بها إلى الجالسين في الأسفل (أوركيستر) فانطلقت موجة العطس داخل القاعة.
سينما العثمانية، أو "العْثامنْ" كما يحلو لنا تسميتها، كانت تعرف إقبالا كبيرا، خصوصا عندما تعرض أفلاما مشوقة (دوستي/ بيغ بوص..) وكنا نصطف في طابور طويل لأجل اقتناء التذكرة، لكن تواجد هذه القاعة قرب حي صفيحي، يجعل بعض شبان المنطقة يسرقون نقود الأطفال عنوة، فيضطر الطفل إلى مغادرة الطابور عائدا إلى البيت باكيا بشكل هيستيري، وهذا الاعتداء ألفناه، وكنا نخشى أن نتعرض إليه، لكن والحمد لله، لم أسقط ضحية هؤلاء الأشرار الذين كانوا يسرقون لحظة فرح واستمتاع ونشوة من طفل بريء لا حول له ولا قوة.
ونظرا للعوز المادي الذي كان يعاني منه أبناء الأحياء الشعبية، ورأفة بهذه الفئة من الأطفال التي تبحث عن الفرجة، كانت سينما الحسنية المتواجدة في درب ميلان " حي عمر بن الخطاب حاليا"، تعرض فيلما واحدا صبيحة يومي الجمعة والأحد بسعر لا يتجاوز خمسين فرنكا(سنتيما)، وغالبا ما كان يقع اختياري صحبة أصدقاء الحي على هذا العرض المناسب لوضعيتنا، ومع ذلك، فقد كنا نجد صعوبة في توفير ثمن ولوج القاعة، بالإضافة إلى عشرة فرنكات للمضيف، هذا الرجل، كنا نكرهه لقساوته، وقد اشتهر بمقولته (فلوس الفابور) وكنت وأصدقائي في الغالب لا نمنحه، فيكون المصير عقابا بدنيا تهيأنا له نفسيا وجسديا قبل الدخول، حيث دائما نفضل المقايضة معه، باستبدال عشرة فرنكات (جوج دريال) بضربتين على الظهر بسياط أو حزام، ونحن نهرول فارين إلى داخل القاعة، نجلس على الكراسي ننتظر بشغف كبير انطلاق الفيلم، غير عابئين بألم العقاب .
لا أخفي، أني الآن تنتابني من حين لآخر رغبة في إعادة الأفلام التي شاهدتها وأنا طفل، فلا أبخل في التفرج عليها عبر شبكة الانترنيت، والفرحة تغمرني والنشوة تتسلل إلى دواخلي.
صعب جدا أن تنمحي من ذاكرتنا لحظات سعادة ولدها الحرمان.







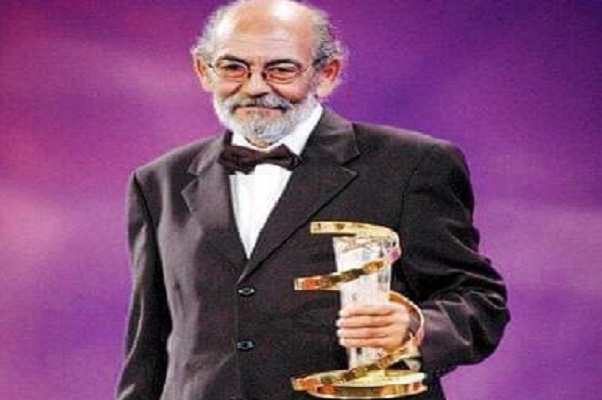






تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي سكوبريس